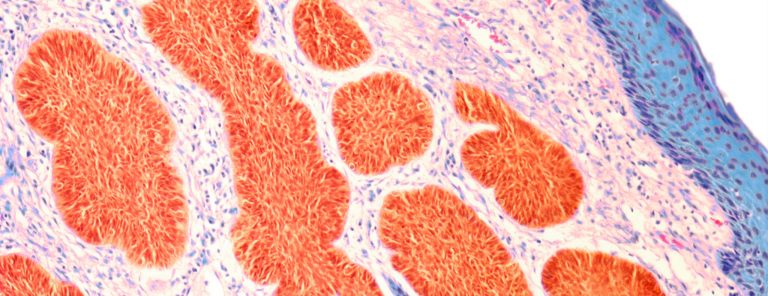جنكيز أكتار* – (أحوال تركية) 28/2/2020
تبدلت الأمور بشكل كبير بعد سنوات الحرب الأهلية التسع في سورية. أولا وقبل كل شيء، صُبغت الانتفاضة بصبغة راديكالية تماما وهيمن عليها تنظيما “داعش” والقاعدة. وجاء الجهاديون الأجانب من كل حدب وصوب للانضمام إلى تنظيم “داعش”، الذي أخذ يتوسع بينما خسرت المعارضة كل التعاطف الدولي الذي كانت قد كسبته في بداية الصراع. واليوم، باتت تركيا وحدها تقف إلى جانب المعارضة، إلى جانب مداهنة الدول الغربية. وبات من شبه المؤكد أن المعارضة الجهادية في سورية لن تحصل على أي شيء يُذكر من مباحثات السلام المستقبلية، عندما تتحرر المنطقة من الغزو والتدخلات الخارجية.
- * *
كان من المفترض أن يتوجه زعماء ألمانيا وفرنسا وروسيا –المستشارة أنجيلا ميركل، والرئيسان إيمانويل ماكرون وفلاديمير بوتين– إلى إسطنبول لإجراء اجتماع مع “شخصِي”. هكذا يصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه، خاصة عندما يلتقي زعماء دول أجنبية. وبطبيعة الحال، كان أردوغان هو الذي دعا إلى عقد هذه القمة، وهي واحدة في قائمة طويلة، وقرر ماكرون وميركل الانضمام إليها على عجَل؛ لكن ذلك انتهى، للأسف، إلى الفشل مع رفض بوتين الشديد لعقد الاجتماع.
كان موضوع النقاش حسب الإعلان الرسمي هو كيفية التوصف إلى وقف لإطلاق النار في مدينة إدلب الواقعة شمال غربي سورية. لكن الأجندة الخفية للأوروبيين، وعلى وجه الخصوص ألمانيا، كانت كيفية ضمان عدم تدفق المزيد من اللاجئين السوريين على أوروبا من تركيا عبر اليونان، وذلك من خلال إقرار وقف إطلاق النار المفترض. وكانت أجندة أنقرة الخفية هي كسب الوقت لصالح الجهاديين التابعين لها في إدلب.
والافتراض الأساسي واضح جداً، وهو أن العملية الجارية التي ينفذها الجيش العربي السوري والقوات الجوية الروسية في إدلب تتسبب في نزوح اللاجئين، وأنه يجب منع هذا كله من خلال وقف لإطلاق النار. وبالمناسبة: لم يسبق أبداً أن كانت هناك حرب من دون لاجئين!
على مدى أشهر، ظلت وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، تدق ناقوس الخطر وتحذر بصوت عالٍ من أن العملية العسكرية الجارية لاستعادة إدلب في شمال غربي سورية ستخلق أزمة من العيار الثقيل في المدينة التي تعج بالمسلحين المتطرفين، والتي يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين مدني حسبما تشير التقديرات.
ووفقاً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن التقديرات تشير إلى أن “أكثر من 900 ألف شخص تركوا منازلهم أو الأماكن التي كانت تؤويهم في إدلب خلال الأشهر الأخيرة. ومعظم هؤلاء موجودون الآن في شمالي إدلب وفي حلب، وهو الأمر الذي يعقد الوضع الإنساني الكارثي مسبقا هناك، في ظل برودة الطقس الشديدة.
وتقول المفوضية: “تشير التقديرات إلى أن هناك حاليا أكثر من أربعة ملايين مدني في شمال غربي سورية، أكثر من نصفهم نازحون في الداخل. وظل الكثيرون يعيشون كنازحين لسنوات، واضطروا إلى الفرار عدة مرات. ويتكون نحو 80 في المائة من النازحين الجدد من النساء والأطفال. ويواجه الكثير من المسنين أيضا أوضاعا خطيرة”.
ووفقا لمبعوث النظام التركي إلى الأمم المتحدة، فإن “الأزمة في إدلب تزداد سوءاً. يستمر النظام في استهداف المدنيين، وإخلاء المدن والقرى. وقد نزح أكثر من مليون شخص داخليا خلال الشهرين الأخيرين، وهذا هو أكبر نزوح جماعي منذ العام 2011. الناس في إدلب يعيشون بين مطرقة العنف وسندان البرد القارس ونقص الغذاء. هذه المأساة الإنسانية لها تداعيات خطيرة تتجاوز حدود سورية. يجب على مجلس الأمن الدولي أن يرفع صوته وأن يرسل رسالة واضحة: يجب على النظام أن يتوقف عن قتل شعبه. لا بد أن تتوقف الانتهاكات على الفور لتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية الكارثية مسبقاً”.
أخيراً، دعا 14 من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء الماضي إلى وقف العملية التي ينفذها الجيش العربي السوري وروسيا، وذلك في خطاب مشترك لصحيفة (لا ستامبا)، والذي قالوا فيه إن كارثة إنسانية تحدث هناك.
ما من شك في أن النظام السوري بعيد كل البعد عن أن يكون بريئاً؛ إنه يتحمل نصيب الأسد من المسؤولية عن الحرب الأهلية الدائرة في البلد منذ تسع سنوات. وقد حكم العلويون الأغلبيةَ السنية لعقود بقبضة من حديد، على الرغم أنهم أقلية.
ظهرت ملامح الإبادة الجماعية بوضوح أول الأمر في المذبحة التي ارتكبتها القوات الحكومية بحق أهالي حماة لقمع انتفاضة شباط (فبراير) في العام 1982، حيث قُتل نحو 20 ألف شخص خلال ثلاثة أسابيع -وفقاً لتقديرات منظمات حقوق الإنسان. وتُعتبر تلك المذبحة من أسوأ جرائم الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في الشرق الأوسط خلال القرن العشرين. ومع ذلك، لم يتم إجراء أي تحقيقات في تلك المذبحة، ولم تتم مناقشتها علناً. ولانتفاضة العام 2011 والحرب الأهلية الدائرة جذور نابعة من الانتهاكات التي لا تُحصى بحق المسلمين السُنة على وجه الخصوص، وبحق الإخوان المسلمين في سورية.
ومع ذلك، فقد تبدلت الأمور بشكل كبير بعد سنوات الحرب الأهلية التسع. أولاً وقبل كل شيء، صُبغت الانتفاضة بصبغة راديكالية تماماً وهيمن عليها تنظيما “داعش” والقاعدة. وجاء الجهاديون الأجانب من كل حدب وصوب للانضمام إلى تنظيم “داعش”، الذي أخذ يتوسع بينما خسرت المعارضة كل التعاطف الدولي الذي كانت قد كسبته في بداية الصراع. واليوم، باتت تركيا وحدها تقف إلى جانب المعارضة، إلى جانب مداهنة الدول الغربية. وبات من شبه المؤكد أن المعارضة الجهادية في سورية لن تحصل على أي شيء يُذكر من مباحثات السلام المستقبلية، عندما تتحرر المنطقة من الغزو والتدخلات الخارجية.
لسوء الحظ، فات الأوان، في ظل الوضع الراهن، للدعوة إلى وقف لإطلاق النار والحديث الصاخب عن ضرورة أن يجد المجتمع الدولي حلاً سياسياً للحرب الأهلية في سورية. ومن الواضح جدا أن المجتمع الدولي لم يفشل في هذه المهمة فحسب، وإنما باتت الأطراف تتبنى الآن مواقف متضاربة. ولهذا السبب تحول ما بدأ كنزاع محلي إلى حرب أهلية.
وفيما يتعلق “بالكارثة الإنسانية”، فإن البلدات المتنازع عليها باتت شبه خاوية على عروشها مع استمرار سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء القصف من الجانبين. وهناك أدلة متنامية على أن المدنيين في إدلب وحلب سيكونون أقرب إلى العودة إلى ديارهم بعد القضاء على الجهاديين من أن يعبروا في اتجاه تركيا. وهذه الرغبة في العودة لا تنطبق فقط على النازحين في الداخل، وإنما تنسحب أيضاً على اللاجئين؛ وقد أظهر مسح أجرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في الآونة الأخيرة أن 75.2 في المائة من السوريين في دول المنطقة عبروا عن رغبتهم في إعادة التوطين طوعا.
لماذا إذن كل هذه التحذيرات المثيرة للقلق؟ تتلاقى حسابات أنقرة ووكلائها الجهاديين المتشائمة مع “فوبيا اللاجئين” التي يعاني منها الأوروبيون وانتهازية وكالات الإغاثة الدولية، للإعلان عن حالة طارئة لا وجود لها أصلاً، على الأقل من حيث الحجم الذي يدور الحديث عنه.
و”الفوبيا” الأوروبية موثقة جيدا، ومعروفة بقدر ما هي معروفة انتهازية وكالات الإغاثة. ولكن، ماذا عن تركيا؟
لم تنتهك أي من الدول المضيفة حقوق اللاجئينَ بقدر ما فعلت تركيا؛ فالسوريون في تركيا عمالة رخيصة، وغرباء يعانون من الاضطهاد والكراهية، وكبش فداء من جميع الشرور. والكثير من المنتمين إلى ما يسمى بـ”الجيش السوري الحر” المدعوم من أنقرة جرى تجنيدهم من بين اللاجئين السوريين في تركيا. وعندما سُئل الملك عبد الله بن الحسين، ملك الأردن، في الآونة الأخيرة عن سبب حصول تركيا على مساعدات مالية بمليارات الدولارات بينما لا تحصل بلاده على تلك المليارات، قال غاضبا: “نحن لم نهدد بإرسال اللاجئين إلى أوروبا.. لأننا نعتقد أن هذه مسؤولية ويجب أن نعتني بهم”.
وهناك تناس مستمر لحقيقة أن تركيا ليست الدولة التي تستضيف أعلى كثافة من اللاجئين مقارنة مع عدد سكانها، وإنما لبنان، يليه الأردن. وفي واقع الأمر، فإن هذين البلدين المضيفين للاجئين لا يثيران ضجة حول ضيوفهم، بينما تفعل تركيا ذلك باستمرار.
خلاصة القول أن دعوة أنقرة إلى إقرار وقف لإطلاق النار، والتي يروج لها المجتمع الدولي، إما لسذاجته أو من باب السخرية، تخدم أنقرة ووكلاءها الجهاديين لكسب مزيد من الوقت لإعادة تنظيم الصفوف وتعزيز وجودهم في شمالي سورية؛ فهم يعرفون أن العملية العسكرية السورية الجارية عندما تنجح، ستمتد إلى أنحاء أخرى من الأراضي التي تحتلها تركيا في سورية، وهو الأمر الذي سيُنهي النفوذ التركي هناك.
*كاتب ومحلل سياسي تركي.