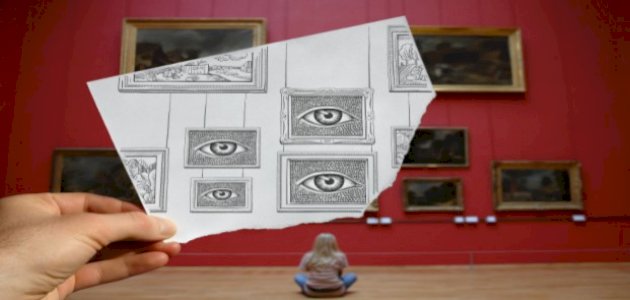مرآة العراقي عبد الأمير طعمة… خفايا المكان وجمالياته
[wpcc-script type=”d49dbb71d87f9fd2fe0ca981-text/javascript”]

جماليات المكان
حين درس جاستون باشلار المكان في كتبه «جماليات المكان»، «أصل النار»، «الماء»، إنما تناول أدق الأشياء في الحيّز الذي يشغله الإنسان منذ نشوء الخليقة وعبر جوّلاته في مجاهل الأرض لمعرفة أيقونات الشعوب الطقسية وأعرافهم، أي منذ ابتداء الكهف كمأوى، فالكهف مكان، والنار مكان لأنها تستقبل الأفعال، والماء مكان، لأنه يستقبل الأجساد ويحتوي الحيوات، فالسباحة في النهر، هي فعل يوازي فعل الطرق على الباب للدخول إلى المنزل، إن الأفعال المقترنة بالأداء تنتج أمكنة أو هي نتيجة لها، لأنها مرتبطة بها كفعالية في الوجود، لذا وجدنا باشلار ينحت في المكان ليستخرج عيّنات منه، فالمكان بحد ذاته مُنتج للأشياء. وما نراه في الفن يعني التعامل مع حقيقته الأنثروبولوجية والنفسية والفلسفية. إن إنتاج المكان لهذه الضروب يعني أنه شديد الصلة بالتاريخ، فالمكان هو الإنسان، والعكس يصحّ، لأن تاريخ المكان من تأريخ الإنسان فيه، فهما توأمان؛ فلا مكان بدون إنسان، ولا إنسان خال من العلاقة بالمكان، هذا التفاعل ينتج مضامين أو معاني، فالمكان بجمالياته، والإنسان بجماليات أفكاره ورصانتها، ينتجان حقيقة أزلية في الوجود، وهي ديالكتيك وجود (الإنسان والمكان والإنسان في المكان)، فباشلار وياسين النصير، خلقا لهما عينا ثالثة، هذه العين محددة بالمكان، وأجد أن النصير شكّل منعطفاً في رؤيته للمكان، كذلك الدكتور أسعد الأسدي في اجتهاداته التي تضمنتها كتبه عن المكان، فهو كمن يتتبع الأثر في المأثور، ليستخرج عيّنة جديدة مقنعة، وهي بمثابة دالة وفعل أخلاقي يتعلق بالمكان. ولعلنا في ما نكتب، إنما لنفتح أكثر باب للدخول إلى تنوّع التعامل مع المكان عند الفنان (طعمة)، وما دفعنا لتخريج مسار قراءتنا وربطها بالمتحرك المعرفي الذي صاغه كل من (باشلار، ياسين النصير، أسعد الأسدي) اجتهاداتهم النظرية عن المكان. لذا فنحن نتعامل مع المكان في الفن من باب استيعاب ممكناته في اللوّحة، بدون الاهتمام بالتخريج الذي قد يعطل نظرتنا، فالمكان في الفن واللوّحة خصوصاً حمّالة أوجه، وهو نوّع من الاجتهاد الجديد في صياغته عبر المنتَج عند الفنان، ونظرتنا هذه؛ إنما تبحث عن خفايا المكان من حيث كون الفنان يتعامل مع التاريخ عبر الذاكرة المكانية. وبهذا تتسع دائرة الممارسة الفنية باتجاه توسيع المفاهيم التي يرتكز عليها، فهو لا يعمل على نقل صورة المكان، محلة، بيّت، سوق، مرفق عام، بوابة مدرسة، مسجد، أضرحة مثلاً، وإنما يبحث في صيرورتها، أي بما تنتجه هذه الأمكنة من محمولات تتعلق بالمجال الاجتماعي والنفسي والديني والاقتصادي، بمعنى يُقدم الفنان صورة لجدلية المكان، معززاً ذلك بوظائفه، منطلقاً من حقيقة فكرية يعتقد أنها دافعة لفعله الإبداعي. ولكي يضع منتجه موّضع الحقيقي، عليه أن يُدقق في تلك العلاقات الخفية، التي تكون دالتها تلك الإشارات المعلنة، وما وظيفة القراءة سوى التدقيق في ما لم يقله النص، بل إنه اكتفى بالإشارة، فنحن مثلاً حين ننظر إلى ما أنتجه نص ما ضمن التوظيفات المتعددة، لا نكتفي بتلك العلامات الواضحة، والمنقولة عن النص المتن، بل علينا أن ننظر بدقة إلى ما أنتجه النص من صوّر ودالات هي حصيلة واجبة للتوّظيف، وهذا يشمل كل الفنون والأجناس، ففي التشكيل نجد الحرف العربي، بما فيه من محمولات، تغيّرت توظيفاته تماماً عند الفنانين ومنهم، أجوّد العزاوي، رافع الناصري، محمد مهر الدين، وغيرهم اختلفوا عن توظيفات الفنان، شاكر حسن آل سعيد، وهو قد اختلف تماماً عن توظيفات من سبقوه في التراث، وحصراً في تخطيطات كتب الحكايات والمرويات في التراث. فالحرف العربي قابل للاجتهاد، لأنه يمتلك مرونة كبيرة، وإيقاعا صوّريا واسعا.
تبدو لوّحة الفنان مركبة من وحدات تؤكد خواص المكان، مهما كان وجوده، فهو بالنتيجة مكان ذو حمولات ذاتية وموّضوعية، فالذاتية منها تخص رؤية الفنان إلى الوحدات الرابطة لأجزاء المشهد في اللوّحة.
ما نريد أن نصل إليه هنا؛ إن الفنانين في اختلافهم بالتعامل مع المكان، إنما حققوا نوّعاً من عكس الفهم الذاتي للمكان، ثم استيعاب حمولاته الفكرية التي تنتج واحدة من ممارساته هي الجمال، لذا فالاختلاف لا يعني القطيعة بينهم، بقدر ما يؤكد الصلة الأبستمولوجية في إنتاج النص البصري. وهذا ما وجدناه في فن الفوتوغراف أيضاً، باعتباره فناً يتعامل مع المكان في كل الأحوال. إن الفنان بما يسعى إليه خلال لوّحته، هو إضفاء الجمال على المكان، لاسيّما الذي يتعلق بالذاكرة، أي الممحو من الوجود لشتى الأسباب، فالاستعادة لصورته يعني ترميم الذاكرة الفردية والجمعية (ينظر لهذا في كتابنا «الذاكرة المستعادة، سِفر الزمان في رؤى المكان» الصادر ضمن مطبوعات اتحاد الأدباء في البصرة عام 2017). فالفنان طعمة شديد الصلة شعورياً بالمكان، وهذا ما قاده إلى تمتين هذه العلاقة والحرص على توفير بلاغة التعامل مع كلياته وجزئياته.
طبقات اللوّحة
تبدو لوّحة الفنان مركبة من وحدات تؤكد خواص المكان، مهما كان وجوده، فهو بالنتيجة مكان ذو حمولات ذاتية وموّضوعية، فالذاتية منها تخص رؤية الفنان إلى الوحدات الرابطة لأجزاء المشهد في اللوّحة، وكما ذكرنا أن أي مفردة تشكيلية تعني المكان وفق رؤية باشلار، أما الموّضوعية فنعني بها تجسيد ما يحسه الآخر لهذه الوحدات، فمثلاً مشهد الشارع تُعززه وحدات كثافة النخيل، ومياه النهر وعمارة البيوت، هذا الكرنفال اللوّني التشكيلي، إنما يعني صورة المكان الذي يحتوي الإنسان، الذي يبدو أكثر بهجة وهو يستقبل الأشياء في المكان. وهذا ما يظهر على معظم نماذجه. إن الفنان في هذه اللوّحة وسواها يعتني بعمارة البيوت، لاسيّما الشناشيل الحاملة لرؤية معمارية مدروسة، تُضفي على المكان جمالية خاصة، إذ نجد معظم الفنانين ومنهم الفوتوغرافيون، يهتمون بهذه العمارة وشكلها المتعدد الخواص ومنهم عادل قاسم، فؤاد شاكر، ناصر عساف، لأنها معالم آيلة للاندثار والمحو وعدم التجديد. فهي عمارة زائلة، تحاول الذاكرة الاحتفاظ بها، والذاكرة الفنية تعمل على تجسيدها بكامل صورتها التي كانت عليها مع تفعيل ممكنات الفن. التركيب يشمل وضع طبقات للوّحة، فهي بذلك حاملة لرموز متعددة، يكون رمز المقدس حاضراً على الدوام ضمن سطح اللوّحة، وهو معلم يجسد حالة الخروج من أزمة الزمن، والدخول في ملكوت ما تحفظه الذاكرة من صوّر جميلة وأصيلة، فالحنين إلى الماضي مرهون بالحاضر الذي يمتلك دوافع لذلك النشاط الذهني.
ففي لوّحتين ظهرت المرأة في كامل بهجتها، سواء من احتلت مكاناً في حقل الزهور، أو الأُخرى التي تمتعت بكامل حريتها وهو تتجوّل في الزقاق لوحدها، فاتحة عباءتها، وهذا دال على محاولة حيازة قسط من الحرية الشخصية بدون وجود الآخر الرقيب، إن الفنان حين خلق الخلوّة في المكان، إنما استجاب لبنية فكرية تخص الأنثى المحاصرة بالآخرين، لذا نجدها تنتبذ مكاناً قصياً عن وجودهم الزائد بمقياس حيازة الحرية. كما أن الفنان اعتنى كثيراً بخصائص المكان ونقله على هذه الصورة من الدهشة، ليس بدافع فني وحسب، أو جمالي فقط، بل إنه استجاب لدوافع فكرية خالصة، تخص مفاهيم يعتقد بها الفرد قبل الجماعة، لأنها تخص تكامل شخصيته في الوجود، إن الذي يُعزز المكان هو الأُلفة السائدة بين قاطنيه، وهذا الأمر أولاه الفنان عنايته، فمعظم من شغلوا المكان يتميزون بالقرابة الاجتماعية خلال ما انطبع عليه سلوكهم مع بعض، فالمرأة تلتقي قرينتها وسط الزقاق، يزيّن المكان الشناشيل وجمع الأطفال وهم يؤدون طقوس لعبهم، أو في لوّحة أُخرى تجلس المرأة الطاعنة في السن، تحت شجرة، تنتبذ زاوية من مكان، بالقرب منها صينية الشاي، وقربها بضع دجاجات يمرحنَّ بحرية بدون مزاحمة، مشهد كان حاضراً لكنه انمحى وغابت أُسسه.
٭ ناقد عراقي