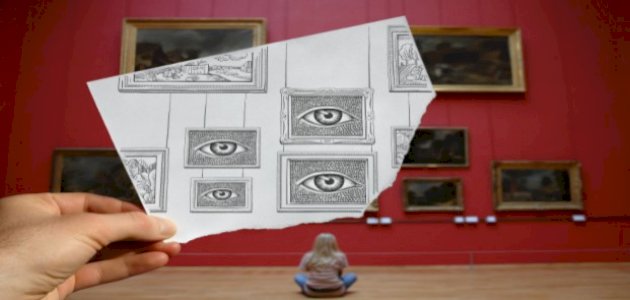في الذكرى الـ32 لرحيل أمل دنقل: الشعر بين المنشور السياسي والتجربة الجمالية
[wpcc-script type=”8634711c2b412d7d9c475b3d-text/javascript”]

القاهرة ـ «القدس العربي»: مرّت منذ أيام الذكرى الثانية والثلاثين لرحيل الشاعر أمل دنقل (1940 ــ 1983)، وقد أقيمت عدة احتفاليات، سواء في القاهرة والإسكندرية، أو في محافظة قنا جنوب مصر، مسقط رأس الشاعر بهذه المناسبة.
وتنوعت هذه المظاهر ما بين الحديث المكرور حول قصائد دنقل الشهيرة، وموقفه من السلطة، وكذا الصفات التي لصقت به كونه شاعر الرفض والمتنبئ بهزيمة 1967، والحاد في موقفه من معاهدة السلام 1977. إضافة إلى ظهور العديد من أبيات قصائده في ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني لتحتل جدران ولافتات الميادين. من ناحية أخرى جاءت الندوات الاحتفالية ليتحدث ضيوفها عن علاقة دنقل بغيره من الشعراء، خاصة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، والخلاف الذي نشأ بينهما، نتيجة موالاة الأخير للسلطة السياسية، والعمل من خلالها. ولكن هل المقاطع الشعرية الشهيرة لأمل دنقل تنتمي لروح الشعر فعلاً، أم أنها للبيانات الحماسية أقرب؟ وما موقفه من بعض رجال السلطة، على رأسهم وزير الثقافة يوسف السباعي على سبيل المثال؟ وإلى متى سيظل جيل الستينيات يمثل سُلطة في الوسط الثقافي المصري، تكاد تضاهي سُلطة ضباط يوليو/تموز 1952 التي لازلنا نعيش توابعها حتى الآن، وهي التي اقتات ذلك الجيل على أحلامها وأوهامها التي هَوَت؟
التجربة الحياتية
لعل أمل دنقل هو أقرب الشعراء إلى روح وفكر الناس العاديين، بعيداً عن المثقفين وجلساتهم، فالرجل لم تنفصم تجربته الشعرية عن حياته، إضافة إلى مُخالطته الفئات المتوسطة والدنيا، شاعراً بآمالهم وأحلامهم، ولتتسع الصورة لتشمل آمال ذلك العصر، أو أوهامه في ما يسمى بالحلم القومي العروبي. ولنا الآن أن ننظر لهذه الأحلام نظرة مختلفة أو مُخالفة لما كان، ومن الأعاجيب أن هناك الكثير من الأجيال الجديدة لم تزل تسير في ركب هذا الوهم. من هنا أصبح الشعر قريباً من لغة الناس، مُحمّلاً بتجربة الشاعر وحِسّه الجمالي. هذا ما يجعل تجربة دنقل مثلاً مختلفة عن تجربة كل من صلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي، والأخير هو الأكثر تأثيراً على دنقل.
تفاصيل الحياة اليومية
ربما ما أضافه دنقل إلى الشعر الحديث هو كيفية التعامل مع تفاصيل الحياة اليومية، وخلق حالة شعرية وطاقة لغوية لهذه المفردات التي تصبح في صورة أخرى داخل القصيدة، من هنا يُعد دنقل من أصحاب ما يُسمى بالقصيدة المشهدية، التي تعتمد لغة الصورة وتكويناتها، والقريبة من التكنيك السينمائي، ومن هنا يصبح الحِس الدرامي والحكائي ملازماً للقصيدة كظلها، كما في هذا المقطع من «سفر ألف دال» …
دقت الساعة المتعبة
رفعت أمه الطيبة
عينها..!
(دفعته كعوب البنادق في المركبة!)
… … … …
دقت الساعة المتعبة
نهضت؛ نسقت مكتبه..
(صفعته يد..
– أدخلته يد الله في التجربة!)
… … …
دقت الساعة المتعبة
جلست أمه؛ رتقت جوربه..
(وخزته عيون المحقق..
حتى تفجر من جلده الدم والأجوبة!)
… … … … …
دقت الساعة المتعبة!
دقت الساعة المتعبة!
السلطة ورجالها
جاء موقف أمل دنقل في غاية الالتباس ما بين سلطة سياسية أصبح يتلو ضدها أبيات حماسية هي للمنشور السياسي أقرب، وعلى رأسها قصيدة «لا تصالح» التي أصبحت أيقونة مكرورة وممسوخة للرافضين والرافضات، الأحياء منهم والأموات، وهي رغم كلماتها القوية والمؤثرة يخبو فيها الحِس الشعري، ويكاد ينعدم ــ الحديث هنا عن لغة شعرية، بغض النظر عن العبارات وما تحمله من معان ــ فالقصيدة ليست بمضمونها، الذي من الممكن أن يحتويه مقال أو خاطرة أو حكمة ومثل شعبي، لكنها في الأخير بنية جمالية، أي .. فن. لنتأمل هذه الأبيات …
لا تصالحْ!
.. ولو منحوك الذهب
أترى حين أفقأ عينيك
ثم أثبت جوهرتين مكانهما ..
هل ترى..؟
هي أشياء لا تشترى ..
ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك،
حسُّكما – فجأةً – بالرجولةِ،
هذا الحياء الذي يكبت الشوق.. حين تعانقُهُ،
الصمتُ – مبتسمين – لتأنيب أمكما..
وكأنكما
ما تزالان طفلين!
تلك الطمأنينة الأبدية بينكما:
أنَّ سيفانِ سيفَكَ..
صوتانِ صوتَكَ
أنك إن متَّ:
للبيت ربٌّ
وللطفل أبْ
هل يصير دمي – بين عينيك- ماءً؟
أتنسى ردائي الملطَّخَ بالدماء..
تلبس – فوق دمائي- ثيابًا مطرَّزَةً بالقصب؟
إنها الحربُ!
قد تثقل القلبَ..
لكن خلفك عار العرب
لا تصالحْ..
ولا تتوخَّ الهرب!
هي عبارات ضد النظام السياسي إذن، وموقف الشاعر من اتفاقية السلام، هذا الموقف يبدو مُغايراً تماماً من أحد رجال هذا النظام، وهو الكاتب ووزير الثقافة (يوسف السباعي) في عهد أنور السادات، والمُبارِك لهذه الاتفاقية، والذي اغتيل بسبب منصبه في قبرص في 18 فبراير/شباط 1978، حيث يرثيه أمل دنقل في قصيدة عمودية، سنترك للقارئ حريّة تلقيها …
لست أنساك واقفاً تتشمس
عند باب من الغصون مقوس
حيث للمرة الأولى شهدتك حلو الخطاب أنيق الملبس…
سوف ألقاك فى مكانك مهما
فصلت بيننا يد ومسدس
سوف ألقاك واقفاً تتحدى
بابتسامتك الزمان فيخرس
خلفك النيل صامتاً يتهاوى
بينما أنت واقف تتشمس
وسأشكو إليك حزنى حتى
يظهر الحزن بي براعم النرجس».
هذه الكلمات التي لو لم يوضع اسم دنقل عليها، لسخر منها مجاذيبه بشدة! الأمر لا يختص به أمل دنقل فقط، هناك العديد من الأدباء والفنانين تورطوا أو اختاروا الوقوف مع وضد في الوقت نفسه، مع شخص وضد ما يُمثله من أفكار، فالمسألة لا تبدو محاكمة للتجربة، بل فقط إعادة نظر. فلا أحد يستطيع إنكار تجربة أمل دنقل، ودوره في الإضافة لديوان الشعر العربي ــ الحالة الشعرية الرائعة في ديوان أوراق الغرفة 8 ــ لكن هذا لا يجعلنا ندور في فلكه كالمجاذيب، من دون النظر مرّة أخرى ومرّات في إنتاجه الشعري، نتفق أو تختلف، وتتغير الآراء وفق مفاهيم وتجارب ورؤى جديدة، سواء بالنسبة لدنقل أو غيره من الأسماء التي أصبحت تمثل سُلطة بذاتها، وتجد مَن يدافعون عنها «عَمّال على بطّال». هنا تأتي حالة التنميط للمثقف أو مُدّعي الثقافة، فلابد من توافر عدة شروط .. أن يكون مُعترضاً ويومئ برأسه رواحاً وجيئة عند سماعه بيانات الشعر الثوري، ولا ضرر من بعض الانفعال والعصبية وتحريك اليدين عند النقاش كالمصابين بأمراض العُصاب، بخلاف النظرة المزمنة للأفق أو اللاشيء. وفي الأخير … لا أحد خارج دائرة النقد، ولا توجد قداسة لفكرة أو لشخص، إذا أردنا بالفعل أن نتحرر من سلطات موهومة نخلقها بأنفسنا، ونجعلها صنماً تطوف حوله عقولنا، حتى تسقط في النهاية.
محمد عبد الرحيم