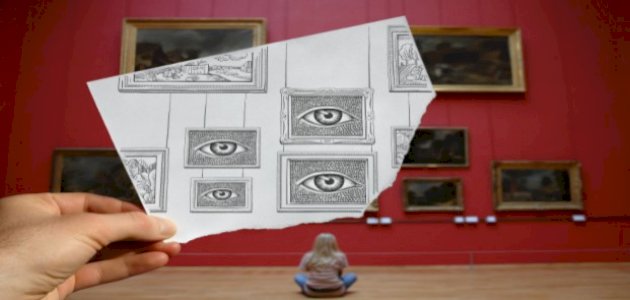كتب الرواية التاريخية واستكشف القاهرة الشعبية: رحيل جمال الغيطاني… الذي عاش الكتابة كمقاومة للنسيان
[wpcc-script type=”eb1e819f5f5491863f47df50-text/javascript”]

القاهرة ـ «القدس العربي»: لا أحد يستطيع أن يُنكر المُنجز الأدبي للكاتب والروائي الراحل (جمال الغيطاني 9 مايو/أيار 1945 ــ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2015)، بغض النظر عن الخصومات والحسابات الشخصية الشائعة في أوساط المثقفين. فما قدمه الرجل للرواية العربية والأدب العربي يُعد إضافة كبيرة، والسعي به عدة خطوات، من تطوير البنية واللغة والأسلوب.
من ناحية أخرى حاول الغيطاني أن يجعل من التاريخ السياسي والاجتماعي المصري متكأ، وإعادة تأويل لما يحدث في العصر الحديث، وكأنه يعيد صياغة الحوادث في سرد خيالي يؤكد رؤيته أو التساؤل الدائم حول اللحظة الراهنة، لأننا مجتمعات تقدس ماضيها، ورغم ذلك يصبح النسيان هو الفرار الوحيد من هذا الثقل، ليأتي الرجل ويُعيد الحكايا للتذكرة، وربما تنفع الذكرى.
ما أضافته تجربة الغيطاني للرواية العربية هو البناء الصوفي واللغة الصوفية، التي جعلها تمتزج بالنص الأدبي وكأنها من داخله، من دون اغتراب أو إقحام، كما نجد في العديد من النصوص المُتهافتة. ولا نستطيع القول إن كل أعمال الرجل جاءت بالمستوى نفسه، وبالتالي لم تلق النجاحات نفسها أو الانتشار ــ بغض النظر عن دعاية الصحف الفارغة ــ إلا أن هناك عدة أعمال تعد علامة فارقة في مسيرة جمال الغيطاني الروائية، ومسيرة الرواية العربية بوجه عام، منها على سبيل المثال … «أوراق شاب عاش منذ ألف عام» 1969، «الزيني بركات» 1974، «وقائع حارة الزعفراني» 1976، «خطط الغيطاني» 1978، «التجليات» «الأسفار الثلاثة» 1990. وربما من خلال روايتي الزيني بركات و»التجليات» يتضح أكثر ما أضافه الرجل إلى مسيرة الأدب العربي.
مساءلة التاريخ
لم تكن رواية «الزيني بركات» رواية تاريخية، رغم الصفحات الطوال المنقولة عن ابن إياس في كتابة «بدائع الزهور في عجائب الدهور»، التي كان يحفظها الغيطاني تماماً، الأمر كان أشبه بمواجهة التاريخ المصري في حقبة من أشد حقباته ظلاماً. دولة تنهار وغزو جديد يأتي، صراع دولة المخابرات أو البصاصين في لغة ذلك الوقت، ليكون الانهيار التام هو المآل الحتمي. لم يكن الزيني بركات مُحتسب مصر سوى صورة أخرى متخفية من صور قهر الشعب المصري، مهما تظاهر بغير ذلك، ومهما حار الناس في أمره. فها هو يحتفظ بوظيفته نفسها بعد انهيار الدولة، واستتباب الأمر للسلطة الجديدة أو الغزو الجديد/العثمانيين. لم يكن أحد من القادة المماليك يهتم لأمر الشعب، والصراع في ما بينهم هو الأهم والأبقى، الذي فناهم تماماً في النهاية وقضى على وجود دولتهم المُستقلة.
الرواية لا تكتفي بالإسقاطات السياسية لزمن عبد الناصر ورفاقه، لكنها توقفت أكثر عند تحليل سياقات السُلطة ووجهة نظرها إلى المحكومين من أبناء الشعب، وما الإصلاحات الوقتية التي افتعلها الزيني بركات، والتي نال من خلالها تحية الشعب، إلا افتعالات لتأكيد سلطته، التي ظهرت تماماً في علاقته بالمثقف الأزهري في عصره ــ سعيد الجهيني ــ الذي كان يُناديه بابنه، والذي أصبح من دون أن يدري بوقاً له بين طلاب الأزهر، يُقابله طالب آخر أصبح أداة من أدوات رئيس البصاصين «زكريا بن راضي» على الرفاق في المؤسسة التعليمية الوحيدة والمرموقة في البلاد. اللعبة نفسها التي يتصارع فيها أبناء الظروف القاسية، والفئة نفسها، ليخوضوا الحروب والمواجهات بديلاً عن سادتهم. السؤال في النهاية.. هل تغيّر شيء؟
من ناحية اللغة والبنية السردية نجد أن الغيطاني لم يقسم روايته إلى فصول، بل اختار السرادقات بمثابة لوحات سردية، وقد اخذها أيضاً عن ابن إياس، الذي قسّم كتابه إلى سرادقات، وهي التي تليق بالمحافل من أفراح وأحزان. وهنا يبدو أن التحاور مع شخص مثل ابن إياس لم يقتصر على التناص والتحاور والتعديل، أو حتى التعليق على حدث مذكور في بدائع الزهور، بل امتد الأمر إلى الشكل التقني في السرد، من دون أن يخلق أي اغتراب كان عن المتن الحكائي، فبخلاف الشخصيات والحوادث التاريخية الحقيقية، نجد الخيال الروائي يُعيد صياغة الحكاية بالكامل، وفي ظل النص الأساسي لابن إياس. الهدف من ذلك هو تحليل مفهوم السُلطة وتداعياتها على طبيعة علاقات وروح المحكومين، وما يمكن أن تفعله بهم من تشويه لسلوكياتهم وعلاقاتهم، عالم من الفوضى والذعر، كان لابد حتماً أن ينتهي بالهزيمة وضياع البلاد. وهو الأمر الذي وإن كان يخص جزءا من التاريخ المصري، لكنه من الممكن أن يمتد ويشمل المنطقة العربية وممالكها وإماراتها، التي لا تختلف كثيراً من حيث بنية السُلطة وطبيعتها، والتي مهما طال بها الأمد ستسقط لا محالة.
الرحلة التي لا تنتهي
يبدو الحِس الصوفي وتجارب الصوفية وأقطابها، خاصة الشيخ الأكبر «ابن عربي» حاضراً ومسيطراً على نص «التجليات»، وكأن الغيطاني أراد حواراً مع ابن عربي، يتم فيه التعرّض لما كان وما هو كائن والأمل في ما سيكون، وعبر لغة الصوفية وتراكيبها الخاصة تسير الرواية أو الأسفار، وحيث يتفاعل من خلالها العديد من النصوص تراثية كانت أو حديثة، عربية او أجنبية، دينية وتاريخية، وصولاً إلى التراث الشعبي المصري، وما يحمله من روح هذا الشعب ومعتقداته التي تطورت وتحوّرت مع الزمن في ظل سلطة جديدة أو ديانة جديدة، أو إيديولوجيا بشّرت بعالم أفضل. هذه النصوص يستمدها الراوي ويُضيف إليها من ذاكرته وتجاربه اليومية، لا فارق هنا بين خاص وعام، حالة واحدة مُمتدة تسأل وتبحث عن إجابات مهما كانت مستحيلة. فالتناص هنا لا محدود، وإن كان ابن عربي وطريقته ومعراجه هو الأساس، حتى أن تداخل وتمازج هذه النصوص يصعب تصوّر أو العثور على مصادرها في سهولة، فاللغة أحاطت بالعمل ككل، وجعلته من حيث البناء والتراكيب اللغوية وما توحي به في شكل مستقل عما أخذ من نصوص، وهي براعة وتقنية جعلت النص مستقلا بذاته، بناء يختلف عن تفاصيله، وهي تجربة غير مسبوقة في الأدب العربي، رغم العديد من المحاولات السابقة واللاحقة عليها.
لم يقف ابن عربي حائلاً بين حداثة الأحداث والرؤى التي حشد بها الراوي، والمتحدث بضمير الـ(أنا) طوال الرواية، من أن يحاول الراوي إعادة بناء الحدث، والتعليق أو حتى مجاراته والسخرية منه. هناك حِس ديني من حيث اللغة والمحتوى، لكنه لا يصبح عقبة سردية في وجه التاريخ، كالتعليق على مقتل السادات، وأن هذا الفعل كان من أمنيات الراوي، لكن شخصا مجهولا جاء وحققه! هنا يختلط السياسي والاجتماعي في لغة عليا، اختارها الغيطاني لتصبح أداة النص الأولى، وليخلق من خلالها عوالم تقترب من الفانتازيا والتغريب، من دون أن تنفي أو تتعارض مع الحدث المعروف للجميع. ومن خلال هذه التقنية يفلت الروائي من بساطة التوثيق إلى أفق الخيال في حده الأقصى، ليصبح النص بدوره وثيقة كاملة، من الممكن محاكاتها أو محاولة ذلك. التفسير النفسي والحِسي للراوي كان الهَم الشاغل لما حدث ويحدث، وبالتالي حمل النص شحنات عاطفية كبيرة، وأثار العديد من الأفكار والرؤى ووجهات النظر بالنسبة للمُتلقي. تناص النصوص خلق هذه الحالة، فلم يكن نصاً تقريرياً يتم قبوله أو رفضه، من خلال تحليل المؤلف للحدث، بل حاملاً رؤى وزوايا ووجهات نظر، رغم الراوي الواحد، إلا أن حالة التساؤل الدائمة طوال النص، التي تتطور من سؤال إلى آخر، ولا تكتفي بإجابة او لا تجد بمعنى أصح، أتاحت للنص أن يصبح في حالة دائمة من التأويل وإعادة التأويل، نص حي، كنصوص الصوفية الكبار، لا ينتهي بمجرد أن يبدأ. ونحاول استعراض شهادات بعض الأدباء حول الغيطاني، سواء من خلال مَن قرأ له أو عمل معه في «أخبار الأدب».
أحد البنائين الكبار
بداية يذكر الشاعر عيد عبد الحليم، أن الغيطاني… يعتبر أحد رموز الرواية المصرية والعربية في القرن العشرين، وأحد المجددين من جيل الستينيات. منذ عمله الأول «أواق شاب عاش منذ ألف عام». ثم بعد ذلك اتجاهه إلى ما يمكن أن نسميه السرد المعماري، حيث كان الغيطاني أحد البنائين الكبار في الرواية العربية، فقد كان لا يعتمد على الفكرة أو حكاية الأحداث، أو التفاصيل الصغيرة، بل ما يمكن أن نسميه أيضاً بالمشهد الكبير، ولذلك ربما اتجه لفكرة مناقشة الماضي في أعماله، يتجلى ذلك في «الزيني بركات»، والكثير من الروايات الأخرى، كـ»التجليات» على سبيل المثال، وغيرها من الروايات التي اشتبكت مع الماضي اشتباكاً حميمياً، وكذلك ربط هذه الأعمال بما يحدث على أرض الواقع. كما كان الغيطاني أحد أهم التلاميذ النجباء لنجيب محفوظ، الذي كان أستاذه الأول، حيث كان الغيطاني يُجالسه ويعرض عليه ما يكتبه، حتى صار الغيطاني أحد الذين تتفاخر بهم الرواية العربية. من ناحية أخرى لا ننكر إسهامات الغيطاني في الكتابة الأدبية الصحافية، فهو أحد أهم المؤسسين والمؤثرين في الصحافة الأدبية، سواء من خلال رئاسته للقسم الثقافي في جريدة «الأخبار»، أو تأسيسه لجريدة «أخبار الأدب» عام 1993، التي أسهمت في تبني العديد من التجارب والمواهب الإبداعية في مصر والوطن العربي، والتي أصبحت الآن ذات صوت وتأثير في عالم الأدب. كل العزاء لأسرة الكاتب الكبير ولمصر وللوطن العربي.
الموروث والعالم الروائي
ويقول الصحافي والروائي ناصر عراق… برحيل جمال الغيطاني تفقد الساحة الروائية المصرية واحداً من أخلص مبدعيها، وأكثرهم إيماناً بمشروعه الروائي، كما أن الغيطاني استحق أن يكون أبرز أبناء جيل الستينييات الذين تأثروا بالمعلم الأول نجيب محفوظ، لكنه شق لنفسه طريقا مغايرا. هذا الطريق اتكأ على استلهام التراث – المملوكي تحديداً – وإعادة إنتاجه في قوالب روائية متميزة ومترعة بالإثارة والتشويق، وها هي «الزيني بركات» تعد نموذجا مدهشا لفن الرواية المستند إلى استلهام التراث، ويبدو لي أن جمال الذي درس فن النسيج بما يحتشد من زخارف عربية إسلامية تمكن من تعميق علاقته بالموروث الإسلامي/المملوكي، ودرسه جيدا واستوحى مقوماته الأساسية لينطلق منها إلى عالمه الروائي الثري. كما لا يمكن أن ننسى للغيطاني دوره المهم للغاية في ترسيخ الصحافة الثقافية وتعزيزها من خلال رئاسته لتحرير «أخبار الأدب» لنحو 17 سنة، وقد شرفت بالعمل معه في هذه المطبوعة في سنة 1998.
وأشهد أنه كان عليما بالفنون الجميلة وروادها وأسرارها وفنانيها بصورة مدهشة، حيث منحني الصفحة الأخيرة أكتب فيها كل أسبوع في قضايا الفن التشكيلي ونجومه. لا ريب أن رحيل الغيطاني سيترك أثرا شديدا في الوسط الإبداعي العربي والمصري.
الدور التنويري
ويرى القاص والروائي أيمن غانم… أن جمال الغيطاني يُعد علامة بارزة في الحياة الثقافية المصرية والعربية، من جهة تنوع إنتاجه ما بين الصحافة والفكر والأدب، إلى جانب إسهاماته في الحفاظ على التراث التاريخي والحضاري لمصر وعمليات التوثيق التراثي التي قام بها، لاسيما لمناطق القاهرة القديمة، ويظهر بوضوح تأثير الولع بالتراث في أعمال الغيطاني، ليس فقط من حيث استلهام شخصيات، ولكن أيضاً يظهر ذلك في المفردات والتراكيب اللغوية في عدد من أعماله، وحتى في اختياره لعناوين مؤلفاته يظهر أثر التراث. ويبقى أن الدور الأكبر للغيطاني، رحمه الله، هو الدور التنويري، فلم يتوان يوماً عن التصدي للأفكار الظلامية، ولم يكن من النوع الذي يؤثر السلامة في مواجهة الجماعات المتأسلمة ومحاولاتها منع نشر بعض الأعمال الإبداعية، ومع ثورة يناير/كانون الثاني زاد دوره في التحذير من تصدر قوى ظلامية للمشهد السياسي والاجتماعي المصري. كما قدّم الغيطاني إسهاماً كبيراً في تمهيد الطريق أمام العديد من الأدباء الشباب، من خلال تجربته في تأسيس ورئاسة تحرير صحيفة «أخبار الأدب»، التي كانت نافذة واسعة أمام المبدعين، لاسيما أدباء الأقاليم.
ببلوغرافيا
جمال الغيطاني من مواليد جهينة في محافظة سوهاج جنوب مصر في 9 مايو 1945. انتقل إلى حي الجمالية في مصر القديمة، وتلقى تعليمه في مدارسها، حتى التحق بمدرسة العباسية الثانوية الفنية التي درس فيها ثلاث سنوات فن تصميم السجاد الشرقي وصباغة الألوان، وتخرج فيها عام 1962. تم اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول 1966 حتى أطلق سراحه في مارس/آذار 1967. عمل مراسلاً حربياً من خلال مؤسسة «أخبار اليوم» من عام 1969 حتى عام 1974. كما شارك في تغطية الحرب اللبنانية، وكان على الجبهة العراقية خلال الحرب مع إيران. بعدها انتقل إلى قسم التحقيقات، وفي عام 1985 أصبح رئيساً للقسم الأدبي في الجريدة نفسها. أسس ورأس تحرير جريدة «أخبار الأدب» عام 1993. تحول العديد من أعماله إلى شاشة السينما والتلفزيون، مثل فيلم «حكايات الغريب»، و»أرض أرض»، ومسلسل «الزيني بركات».
الجوائز …
جائزة الدولة التشجيعية للرواية 1980
وسام الاستحقاق الفرنسي من طبقة فارس 1987.
جائزة سلطان العويس 1997.
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.
جائزة لورباتليون لأفضل عمل أدبي مترجم إلى الفرنسية عن روايته «التجليات» 2005.
جائزة جرينزانا كافور للأدب الاجنبي – ايطاليا 2006
جائزة الدولة التقديرية 2007.
جائزة معهد العالم العربي في باريس، عن قصة «نثار المحو» 2009.
جائزة النيل للفنون والآداب 2015.
محمد عبد الرحيم