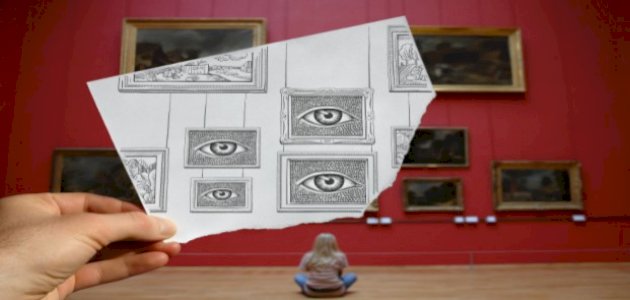قراءة في محور ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 46: «تجديد الخطاب الديني»… ندوات شكليّة بتوجيه سياسي
[wpcc-script type=”8e922fc60e972e00b833e3bf-text/javascript”]

القاهرة ـ «القدس العربي»: جاء المحور الرئيسي لندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام تحت عنوان «تجديد الخطاب الديني»، إضافة إلى اختيار شخصية الإمام محمد عبده كشخصية العام، بما أنه من أبرز المحدثين في الخطاب الديني في العصر الحديث.
وذلك من خلال عدة ندوات أقيمت طوال أيام المعرض، وتحدث فيها العديد من المهتمين، سواء بالفكر الديني، أو بشأن تحديث الفكر العربي عموماً. ورغم الاختلاف على الشخصية المُختارة، بما أن الأستاذ الإمام كان من المحدثين الكلاسيكيين، وهو إلى التوفيقيين أقرب، بخلاف شخصيات أخرى حاولت أن تقيم القطيعة الفكرية مع الأفكار الأصولية، وقد دفعت ثمن موقفها هذا، كالشيخ علي عبد الرازق وهو خير مثال لتجسيد الحالة. إضافة إلى أن فكرة التجديد، وكما قال وذكر أدونيس في محاضرته بأنه لا يوجد ما يُسمى بتجديد الخطاب، بل تجديد تأويله، هذه هي المشكلة المزمنة في الفكر العربي، الذي لم يخرج من عباءة العصور الوسطى. ووضع شروطاً للخروج من هذه الأزمة، لكنها في غاية الصعوبة، خاصة أن مفهوم الدولة في العالم العربي لم يزل يحبو ولم يتطور عن مفهومها في العصور الوسطى، رغم الشكل الحديث الهش.
من ناحية أخرى نجد أن الندوات وإطارها العام جاء مُسايراً لشكل تريد أن تبدو الدولة عليه، ولا يخفى التوجيه السياسي كالعادة في وضع برنامج الندوات واختيار محاورها، وتجنيد بعض رجال الدين والمفكرين المتأسلمين لمُحاربة وضع سياسي قائم، قبل أن يكون الأمر محاربة أفكار متمكنة من قطاع عريض من الناس، خاصة بعد انهيار المشروع القومي، وبداية عصر جديد في سبعينات القرن الفائت، وهو ما أصل للوضع المتردي الذي تعيشه مصر الآن، خاصة.. الفكر الأحادي والدين الرسمي والتعالي وتكفير الآخر. فإن لم يكن الوضع السياسي مُلحاً الآن لما التفت أحد لمثل هذه الأفكار، ولهذا نشك في جدوى ما يحدث، وما سيحدث من تأثير على أرض الواقع، اللهم إلا بالقوة، من دون الفكر. ونستعرض هنا أهم ما جاء خلال هذه الندوات، خاصة التي حاولت الخروج عن الإطار الضيق المرسوم، واتسمت بعمق الرؤية ووجاهتها.
الأصولية والحضارة
في ندوة كان أبرز حضورها مراد وهبة، صاحب المشروع الطويل في محاربة الأصولية أكد أن الأوليات بدأت تطول جميع الأديان في النصف الثاني من سبعينيات القرن الفائت، وصارت تيارا عالميا، وبالتالي وجدت كل ديانة نفسها تمتلك اليقين والحقيقة المُطلقة، وهذا ما جعل الصراع قائماً بين مختلف الأديان، وأعلى صورة لهذه الأصوليات تتجسد في الإرهاب.
وأشار إلى أن العلمانية ـ تحويل المُطلق إلى نسبي ـ هي الحل الأمثل. وذلك من خلال معالجة مفهوم الدين، في مراحله الثلاث.. الإيمان، المعتقد، فرض هذا المعتقد. ومرحلة الإيمان حالة شخصية بالفرد، أما المُعتقد، خاصة في حالة وجوده كمعتقد مُطلق، فإنه بذلك يمنع أي اجتهاد، ويصف مَن يُخالفه بالكُفر، وهنا لابد من إعمال العقل، وبالتالي اللجوء إلى تأويل النصوص، ويستشهد وهبة بمقولة ابن رشد «لا تكفير ولا إجماع مع تأويل» هذا المنهج التنويري يقابله منهج ابن تيمية، المُسيطر على الفكر العربي، وأساس أفكار الوهابية وامتدادها حتى اللحظة الراهنة، وهو ما يُفسر الخروج عن ركب الحضارة، والعيش كعالة على العالم.
فساد كتب التراث وفقهاء السلطة
اعترض أستاذ التاريخ محمود إسماعيل عن مصطلح تجديد الخطاب الديني، وأشار إلى كونه مقولة مُلتبسة، فلا تجديد في العقائد، ولكن في الشريعة، خاصة الأحكام المُتغيّرة. وهنا تأتي مسألة أو مشكلة الفقهاء، الذين يصوغون العلاقات بين الناس وبينهم.. وبين الناس والسُلطة. وتاريخ الفقه موصوم بسعيه وراء السلطة، والدوران في فلكها. فالأحاديث على سبيل المثال كُتبَت بعد وفاة الرسول بقرن ونصف القرن، إضافة إلى الصراعات المذهبية التي لعبت دوراً كبيراً في إفساد هذا التراث، ويرى إسماعيل أن آلاف هذه الكتب لا يحتاج إلى تنقيح، بل إبادة.
ولا يدعو إسماعيل إلى القطيعة مع التراث، لكن التأسيس عليه من دون إلغاء بناء على أسس واضحة، والنظر لأعمال المستشرقين عن الإسلام، لما لها من أهمية وعقلية ناقدة، وتحكيم عقلنا في ما نقرأ ونبني عليه.
المفارقة بين النظام الديني والاجتماعي
بداية يوضح عبد الجواد ياسين أن النظام الديني ليس الدين، لكنه إنتاج الاجتماع أي التديّن، وهو نسبي، أما الدين فمطلق. وعليه يفرّق ما بين النظام الديني الذي تم تجميده تحت دعوى تقديسه، وبين النظام الاجتماعي المُتغيّر دوماً، وأن الأزمة تكمن في عدم مُسايرة الأول للثاني، ويتفق ياسين مع الرأي القائل بأن النظام الديني كان إفرازاً لنظام اجتماعي بالأساس ــ سنوات الإسلام الأولى ــ والتناقض ما بين الثابت والمتغيّر يتم دوماً رفعه لصالح المُتغيّر، أي للنظام الاجتماعي.
ويضرب ياسين مثلاً بحالة النظام الديني والسياق التاريخي والاجتماعي في كل من أوروبا والشرق، فبينما نجح النظام الاجتماعي في تراجع الكنيسة الكاثوليكية، بعد الصدام بينهما، لم يحدث الأمر نفسه في الشرق، لأن درجة التغيير لم تصل إلى مرحلتها الحادة، فالعلاقة حتى الآن متوترة، ولم تصل بعد إلى مرحلة الصدام.
التحديث وشروطه
وتحدث المفكر التونسي عبد المجيد الشرفي عن تحديث الفكر الديني، من دون عنوان الندوة غير المنضبط/التجديد، وأشار إلى دراسته للمسألة الدينية في حيادية، وهي من الصعوبة في العلوم الاجتماعية. وتطرق الشرفي إلى مفهوم (الإجماع)، الذي تم تحوله ليصبح تميّز وسيطرة فئة على سائر الفئات الأخرى، من جهة أخرى هناك تناقض واضح بين سلوك الإنسان الآن ودينه، والتحديث بذلك ينصب على أشكال التدين، أي أشكال الفهم للدين، ومدى التوافق ما بين مقتضيات ومتغيرات العصر وبين الموروث الديني.
ويتعمق الشرفي في المشكلة أكثر، موضحاً أن العلاقات السياسية والاجتماعية والجنسية كلها مؤسسات بشرية، ولا يوجد منها ما يخضع للفكر الديني، أما إخضاعها للأحكام الشرعية ــ الخاصة بظرف زماني ومكاني معين ــ والادعاء بأنها أحكام صالحة صلاحية مُطلقة، فهو أمر يخرج عن التطور المعرفي. ولا معنى للتحديث إذا اقتصر على فئة من المجتمع دون أخرى، وان يمتد إلى عقول الأغلبية، وإلا أصبح عديم التأثير وغير ذي جدوى.
ولهذا التحديث شروط يجب الالتفات إليها… كالنظر إلى هذا الفكر الموروث بأنه يخص مجتمعا رعويا بدائيا، فالأمر مرهون بكفاءة الفرد وليس بمدى طاعته، والشرط الأهم هو نظام الحكم السياسي، وتغييره بأن يقوم على المشاركة لا الاستبداد، وإقرار مبدأ المواطنة.
الفصل بين الدين والهوية
ويرى الناقد اللبناني علي حرب أن المشكلة تكمن في جمود المؤسسات الدينية، التي لم تستطع إنتاج خطاب يواكب التقدم الحضاري، رغم ما يوجد في التراث مما يسمح بإنتاج نص حضاري، وعقد حرب المقارنة بين ثروات العرب وفقرهم الفكري والمعرفي، خاصة النقدي.
والمشكلة تكمن في الوقوف عند الدفاع عن الهوية، دون الحرية التي هي أجدى، وهو ما أدى إلى الفشل في الإصلاح الحضاري وشروطه.. المعرفة والديمقراطية والتنمية. ولا إصلاح في الفكر إلا بإصلاح مَن يدّعون أنهم حُرّاس الدين. ويوضح الفكر الديني أن تفسير النصوص يحل محل الأصل/النص، وهي كارثة المشروع الأصولي، فكلام المفسرين يصبح اهم من كلام الله والرسول، وهو ما يُفسر الصراع بين الفرق الإسلامية، ومَن يتصدرونه هم أئمة هذه الفرق والمذاهب.
ويرى حرب أن الأصولية الدينية تجد صداها في التراث والحداثة معاً، فالنظم الشمولية كانت هي النموذج الأمثل لهذه الحركات. وما أصحاب المشروع القومي او الديني إلا وجهان للعملة نفسها، والاختلاف في المسميات كالزعيم أو المرشد، إلا أن الهدف هو نفسه… الوصول إلى السلطة ونفي الآخر. ولن يبدأ الإصلاح حسب رؤية علي حرب إلا بالفصل بين الدين والهوية، فلا توجد دولة ذات حضارة مُنتجة تستخدم الصبغة الدينية عنواناً لها.
ومن خلال نظرة إلى ما سبق من هذه الخطابات والرؤى المتعددة، التي دارت في دائرة الرؤى النظرية في أغلبها، نجد أن وجاهة الحلول تصطدم بالواقع، فالأمر إذا ما تم تفعيله بالفعل، وأن تحدث نهضة فكرية، فلابد وأن تحدث على مستوى القطاع العريض من الناس، ومن خلال تطور واقعهم، وإدخال التحديث على مجالات تبدأ بالسلطة السياسية، ولن يحدث ذلك إلا من خلال ضغط شعبي، لا تفرّط السلطة السياسية العربية في ما تمتلكه، لن تمنح حقاً لرعاياها، وأن تتنازل ولو جزئياً عن كامل سلطتها، يُساعدها في ذلك رجال الدين، الذين يدورون في فلكها، ويتبنون خطابها، ويأتمرون بتعاليمها، بغية تحقيق هدفها وهو البقاء والاستمرار، أما التغيير فنرى أنه عدوها الأول وعدو مُخلصيها من رجال الدين ومؤسساتهم المتسلطة على مخلوقات الله.
محمد عبد الرحيم