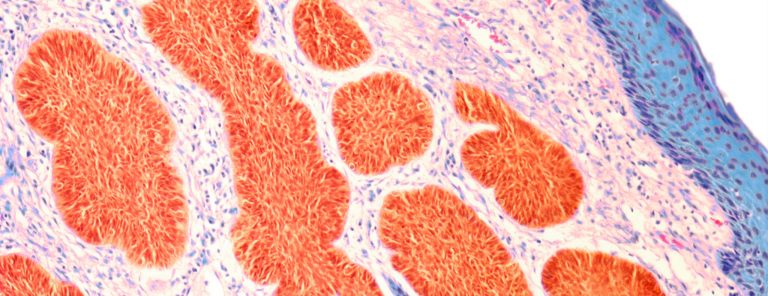5- تحليل ومنافسة نتائج الدراسة:
من أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة الميدانية، وذلك بحثا عن التساؤلات التي طرحت في الإطار التصويري حول مكانة الطب الشعبي محاولين التركيز على أشهر الممارسات العلاجية الشعبية (ألتداوي بالأعشاب ، التجبير ، الحجامة ، الكي ، المسد التوليد …) في ثنايا التحليل والمناقشة:
1- مميزات الممارسين للعلاج الشعبي ومصادر خبراتهم بهذه التخصصات:
تؤكد بعض النظريات إلى أن العلاج الشعبي يعتبر ممارسة اعتقادية تشبع حاجات ثقافية تؤدي وظائف التكيف مع المجتمع من خلال مواجهة المرض وعلاجه، و الوقاية منه بشتى العناصر الثقافية المادية منها والمعنوية المختلفة. لذلك نجد الممارسين لها يشبعون حاجات أفراد المجتمع – (مجتمع محل الدراسة) – فيقدمون له الطلبات الصحية، و يعالجون توتراتهم النفسية و العصبية و يحققون لهم التكيف مع مجتمعهم. وذلك بحكم ما يتصفون به من سمات وملامح (7).
وعادة ما نجد معشر الممارسين للعلاج الشعبي قد بلغوا من الأعوام عتية، فالجبار 70 سنة، والكواي 60 سنة، والحجام 55 سنة، والمساد(ة) 50 سنة، والمداوي بالأعشاب 50 سنة. و بالتالي فإن عمر الجميع يتراوح بين (50 و 70) سنة.
و لعل لكبر السن هذا مغزاه في الممارسات العلاجية الشعبية، حيث يلمح إلى طول المران وعراقة الخبرة، إضافة إلى أن هؤلاء الممارسين للعلاج الشعبي متزوجون جميعهم ولديهم أبناء، إذ يحظى الزواج وتكوين الأسرة بتقدير أفراد المجتمع.
ومما لاحظناه في هذه الدراسة أن الممارسين للعلاج الشعبي بمختلف تخصصاته يزاولون حرفا أخرى في اغلبهم إلى جانب الممارسة العلاجية. كما أن بعضهم قد نال حظه في التعليم مثل (العشاب)، أما البعض الآخر فيقتصر على القراءة والكتابة، بينما نجد (الجبار) لا يقرأ ولا يكتب. ورغم ذلك فإن الممارسين للعلاج الشعبي – ومن خلال ملامحهم هذه الحاجة بلا تردد. ذلك أن الأصول الاجتماعية واحدة، والثقافية متقاربة والأوضاع الطبقية والتصور عن الاخر متشابهة، فهم أقرب إليهم من أفراد النسق العلاجي الرسمي.
أما مصادر خبرة المعالجين الشعبيين فهي متنوعة ما بين الوراثة (الجبّار) و(الكواي) و(الحجام) وبين الاكتساب (العشاب ، المساد ، التوليد). وهكذا لاحظنا أن المهن العلاجية الشعبية تنحصر أحيانا في بعض العائلات المعينة التي تحتكرها مثل (زاوية سيدي بن عمر) منطقة ندرومة. فهي إذن ممارسة وراثية أب عن جد.
أما المصدر الكسبي فهو واضح لدى العشاب الحديث الذي انكب على قراءة كتب التراث وعلوم النباتات بحثا عن أهمية العلاج بالأعشاب والنباتات العلاجية. وعن خصائصها وتركيباتها وفوائدها العلاجية والوقائية ، على أساس أنه يجري التجارب بنفسه ، كما تابع التجارب التي حققها بعض المهتمين عبر عقد ملتقيات ومؤتمرات جهوية ووطنية ودولية حول مكانة وأهمية النباتات و الأعشاب العلاجية. وبهذه الكيفية تتواصل حلقات الممارسة ويستمر النمط العلاجي الشعبي بلا انقراض. وهذا يعتبر في حد ذاته رسوخ لهذا النوع من الممارسة في المجتمع وقبوله ولجوء الأفراد إليه وثقتهم فيه.
2- الممارسات العلاجية الشعبية الأكثر شهرة وانتشارا في مجتمع الدراسة:
لقد لعبت البيئة دورها الأساسي في ازدهار الممارسة العلاجية الشعبية حتى مكنتها من تغطية الاحتياجات الصحية والوقائية لأفراد المجتمع في غياب العلاج الحديث وقصوره في تقديم الخدمات المطلوبة.
وفي ضوء ثـراء البيـئـة الجـزائـريـة بالأعشـاب والنبـاتـات العلاجيـة ، ازدهـر العـلاج بالأعشاب في مختلف مناطق الجزائر (المدينة – القرى – البوادي). من جهة أخرى فإن نذرة الأعشاب العلاجية وافتقادها أحيانا على المستوى المحلي لم يقف حاجزا دون جلبها من الخارج – المشرق – الخليج – آسيا – لاستخدامها في العلاج (8). ولعل من أكثر هذه العلاجات انتشارا في مجتمع الدراسة العلاج بالكي، والحجامة، والتوليد (القابلة)، وأمراض النساء ، والوصفات العلاجية الشعبية المنزلية … الخ.
وقد اكتسب المعالج بالأعشـاب شهرة أوسـع بحكـم صرامة طقوسه ، وتنوع صلاحياتـه ودقة الأعداد والتنظيم له، مما أضفى صرامة ومصداقية على الممارسة، وهذه وتلك من أهم مميزات وطبيعة المعتقد الشعبي (9).
ويذهب المعالجون بالأعشاب إلى أسباب الأمراض التي يعالجونها تعود إلى تعرض الإنسان إلى الرطوبة (مثل أمراض الجهاز التنفسي والروماتيزم) أو الإفراط في تناول الغذاء – خاصة الدسم – والسكريات والحلويات (فيصاب المرء بالسمنة وآلام المفاصل والسكر) ، وكذلك كثرة التعرض للتوترات والقلق (فيصاب بارتفاع ضغط الدم ). والحقيقة أن معظم الممارسات العلاجية الشعبية تخلو من الاحتياطات الوقائية التفصيلية ،عدا المعالجون (القرآن الكريم) فإنهم يحترزون على أعداد إجراءات وقائية قبل البدء في العلاج (الأعمال الطقوسية) و(الرقى) ، و(الحمائل السحرية المتنوعة) ، و(تجنب ارتياد الأماكن الخربة والمظلمة). في حين نجد باقي الممارسات تحتوي إشارات بسيطة عن الوقاية ومنها مثلا أسباب المرض ، مثل التعرض لتيارات الهواء أو التوتر والقلق أو الإفراط في تناول الغذاء عامة والدهون والسكريات والحلويات بشكل خاص.
3- الوظائف العلاجية التي يضطلع بها العلاج الشعبي ؟ ولماذا يقصده مستفيدوه في مجتمع الدراسة ؟
تتعدد الوظائف العلاجية التي يقوم بها العلاج الشعبي في مجتمع الدراسة ، كما تتعدد الأسباب التي تدفع مريديه للإستفادة من خدماته ، حسبما بينته الدراسة الإثنوغرافية التالية :
أ- الوظائف العلاجية للعلاج الشعبي:
هي متعددة – كما أشرنا إلى ذلك سابقا – ويقدمها بشكل يميزه عن العلاج الرسمي ويساعد على توسيع قاعدة المستفيدين منه، والثقة في الممارسين الشعبيين له، ومن ذلك:
1- علاج الأمراض المزمنة والمستعصية (الروماتيزم والسكر والكلى وآلام الظهر والصدع والقولون وارتفاع ضغط الدم) وذلك عن طريق استخدام العلاج بالأعشاب الطبية و الكي، وقراءة القرآن الكريم، زيادة على علاج الأمراض التي لا يعترف بها العلاج الرسمي مثل (اللمس والمسد).
2- إيجاد متنفس يلقى عليه مستفيدوه تبعة توتراتهم النفسية والعصبية وقلقهم نتيجة الضغوطات الاجتماعية التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية، ويتمثل ذلك فيما يقدمه معالج الصرع من ممارسات طقوسية معقدة يعجز العلاج الرسمي صراحة عن إدراكها.
3- تقديم العلاج الناجح والسريع لأمراض العظام (من كسور وفصل وشقوق وفلتات… الخ) وبأدوات جدّ بسيطة مثل (الجبيرة وقطع القماش)، وإجراءات أكثر بساطة مثل (التدليك بالزيت أو الماء والملح وذلك بتحريك المفاصل أو الضغط على الأرجل) وفي أقل وقت ممكن. ولذلك تدعم الثقة بين الممارس لهذا العلاج ومريديه من المرضى.
4- ربط الإنسان المعاصر بتراث الأجداد واستحضاره واثبات فعاليته في مقابل الثقة المعاصرة – والعلاج الحديث منها على سبيل المثال- ومن ذلك العلاج بالأعشاب والنباتات الطبية الذي يربط المريض بأرضه وأعشابها ونباتاتها، كما تربطه بتراثه الذي خلفه السابقون. وبهذه الطريقة تتأكد الهوية وتدعم الأصالة.
5- تحديد رموز ثقافية واجتماعية لتتجه نحوها شحنات غضب المرض وذويهم، ومن ذلك الرموز (الريح الأسود والريح الأحمر) و(الأعمال السحرية)، وهذه عادة ما تلاقى لدى مجتمع المستفيدين قبولا متزايدا، بحيث تتسق مع السياق الاجتماعي والثقافي السائد.
6- يعد التراث العلاجي مصدرا يستلهم منه بعض المعالجين الشعبيين مقومات نجاحهم في مواجهة العلاج الرسمي، مثل العشاب الذي يجري التجارب بنفسه على الأعشاب ويستخلص وظائف جديدة علاجية لنباتات وأعشاب موجودة وغير مستغلة مثل (السكران) المستخدم في علاج أمراض الجهاز التنفسي. وتلك على العموم خاصية غلبت على العلاج العربي منذ القدم (10).
7- تقديم العلاج بطريقة تجمع بين الترويح والتنفيس – عن التوترات والضغوط – والعلاج في نفس الوقت، كما هو الحال في طقوس علاج الصدع. ممارسة تتضمن رموزا عديدة مثل الأضحية والبخور والخيوط (الأدوار والأغاني)، بشكل لا يتحقق في الحياة اليومية. وبالتالي تتعدد الوظائف التي تقوم بها طقوس المعالجة ، وبما يؤكد صدق النظرية الوظيفية الواردة في الإطار التصويري للدراسة ، وكذلك نظرية “العلامات” أو “الإشارات”.
8- أداء الخدمة العلاجية بالأسلوب المرن يقبله المرضى وذويهم ويحبذونه فلا يشعرون بالاغتراب ، وبالتالي يعتمد على العلاج الشعبي ويعتبرونه جزءا من هويتهم وكيانهم.