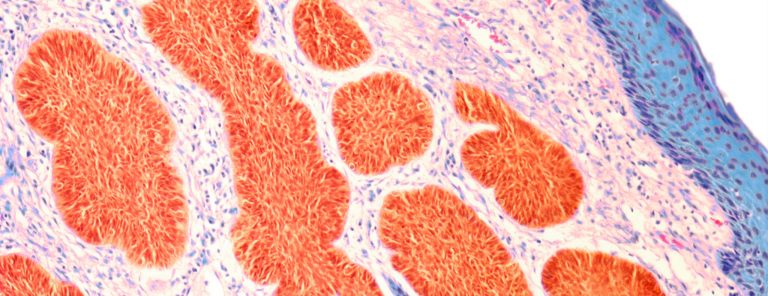مجالات الدارسة الميدانية :
1- الميدان الجغرافي :
هو ميدان متسع نسبيا حيث ضم تلمسان نموذجا وبعض المناطق المجاورة لها ، ولعل مرد
هذا الاتساع هو أننا أردنا أن نبحث عن الممارسين الفعليين للعلاج الشعبي وكذلك الأماكن التي يستقرون بها ويقدمون خدماتهم العلاجية لأفرادها ، وبالتالي يتمركزون فيها. ومراكز تجمع هؤلاء الممارسين للعلاج الشعبي باختلاف تخصصاتهم. فالعشابون (العطارون) يتمركزون في منطقة تلمسان مقر الولاية ، والجبارون (تجبير الكسور والفلتات المفصلية) يتمركزون في منطقة القبار وسيدي ورياش (ولهاصة)، على حين يتمركز الممارسون للعلاج (بالقرآن الكريم) بمنطقتي (عين غرابة) و(الرمشي). وبهذه الطريقة لاحظنا تفاوت بين المناطق السكنية من حيث التخصصات العلاجية الشعبية المعنية مثل (التجبير) و(علاج الصرع) و(التداوي بالأعشاب).
2- الميدان البشري :
والمراد به مجموعة الأفراد الذين شملتهم الدراسة الميدانية والحقيقة أنها مجموعة متنوعة
بحيث تضم ثلة من الممارسين للعلاج الشعبي والأكثر شهرة ومجتمعا (العشاب والجبار والكواي) وجماعة أخرى من المجتمع المستفيد من الخدمات العلاجية.
أما العلاج بالتجبـيـر فقـد أجريـت دراسـة الحالـة والمقابلـة مع شخص يحتـرف ويـزاول
ممارسته بمنطقة (القبار). وقد جالسناه وأجرينا معه مقابلة ومع بعضهم طبقنا دراسة الحالة بالإضافة إلى المجتمع المستفيد من العلاج من من الذكور والإناث ، حيث قمنا ببعض الاستفسارات بغرض التعرف على خصائصهم ودوافع لجوئهم وترددهم على العلاج الشعبي دون غيره من الخدمات الصحية الرسمية.
على حين أجرينا الدراسة الميدانية على اثنين من الممارسين للعلاج بالأعشاب أولهما عشاب تقليدي ورث المهنة ولم يضف إليها جديدا. أما العشاب الثاني فقد اكتسبها عن طريق القراءة والاطلاع على الكتب العلمية حول العلاج بالأعشاب والنباتات الطبية وخصائصها وأنواعها. ثم أجرينا مقارنة بينهما للتعرف على الفوارق بين الخبرة الموروثة والمكتسبة، زيادة على دراسة الحالة. كذلك فقد امتد الميدان البشري هنا ليغطي بعض الأفراد الذين يلتمسون العلاج من العشاب وحالاتهم المرضية ، وسلوك المرض معهم.
3- الميدان الزمني :
عبارة عن فترة وقتية طويلة نسبيا ، فقد استقرت فكرة الدراسة خلال نهاية 2006 (أكتوبر-
نوفمبر- ديسمبر). ثم بدأت الاستعداد لها على فترات متقطعة إلى أن انطلقت في تجسيدها بداية من فبراير 2007، حيث أجريت الدراسة الميدانية حينئذ لتنتهي مع نهاية السنة نفسها بعد أن استغرقت الدراسة حوالي عشرة أشهر.
3- الإطار التصوري للدراسة الميدانية:
المعلوم أن العلاج الشعبي عبارة عن مجموعة من الممارسات والتصورات المتصلة بصحة الإنسان ومرضه ، يؤمن بها ويعتقد فيها اعتقادا جازما لا شك فيه، وبالتالي يغلب عليها الطابع التاريخي والرسوخ وسعة الانتشار. ولذلك نجد ثلاث فئات من النظريات التي تحاول إلقاء الأضواء على هذه المعتقدات والممارسات (4).
الفئة الأولى ومهمتها البحث عن أسباب هذه المعتقدات والممارسات وأسباب التمسك بها. ومنها النظريات النفسية والنظريات الاجتماعية. والفئة الثانية تنظر في الوظيفة أو الوظائف التي تضطلع بها هذه الممارسات والمعتقدات في المجتمع الذي توجد فيه ، ثم كيف تسهم في تدعيم وتوطيد العلاقات الاجتماعية المنظمة ، ومنها النظريات الوظيفية . وتقيم الفئة الثالثة من النظريات ارتباطات بين المعتقدات والممارسات العلاجية الشعبية وبين بنية المجتمعات المختلفة ومنها النظريات البنائية. والأرجح أن الفئة الثانية (النظريات الوظيفية) هي أبرز هذه الفئات حيث تضم نظريات وظيفة واسعة النطاق ، تبرز دور المعتقدات والممارسات الشعبية في والجود الاجتماعي والوفاء به بطريقة أو بأخرى. ونظريات وظيفية ضيقة النطاق وأقل طموحا ،وهي – مهما كانت نقائصها – تقدم إسهامات معينة للهدف المرغوب اجتماعيا. وتذهب هذه النظريات الوظيفية إلى أن الممارسات والمعتقدات العلاجية الشعبية تسهل للأفراد التكيف مع المجتمع الذي يعيشون فيه ، كما أنها تمكنهم من إيجاد متنفس لقلقهم ومتاعبهم النفسية ، ويجدوا راحة لما يعانون منه ، ويصدق ذلك كثيرا على حالات العلاج بالقرآن الكريم (الصرع والمس والتابعة) بحيث تتيح هذه الممارسات الفرصة للتعرف على الصراع الكامن ، والتوترات التي لا تظهر على السطح ، وهنا تلعب الممارسة العلاجية دورها في تأكيد التضامن وتدعيمه عن طريق التحدد الدرامي لشيء سيء يكون سببا في المرض مثل الكائنات فوق الطبيعة ، أو الأعمال السحرية الضارة. كذلك يؤدي المعتقد والممارسة العلاجية الشعبية أو الوقائية دورها في التصرف نحو الأزمات التي تتوالى على كاهل الإنسان- حتى وإن نجمت عن سوء سلوكه وتصرفاته – وتمنحهم الثقة بأنهم بهذه الممارسة الشعبية يتقدمون خطوات واثقة نحو الخلاص من الأزمات والكوارث. وتنطلق كذلك من “نظرية العلامات” في العلاج الشعبي ، وهي تعتمد على (الإشارة) أو (العلامة) التي تحملها العناصر الطبيعية التي تدخل ضمن الممارسات العلاجية مثل الأعشاب والنباتات العلاجية ، وأجزاء من الحيوانات أو الطيور. وترتبط هذه العلامة بوظيفة علاجية تؤديها للإنسان ، وتتسق مع نوع وهيئة المرض. ومن الدلائل على ذلك أن العشاب يصف النباتات كثيرة البذور لعلاج العقم ، والنباتات المنقطة لعلاج بقع الجسم ، والنباتات الصمغية لعلاج القروح الصديدية المقيحة.
– وفي ضوء هذا الإطار التصويري ، واستقراء بعض الدراسات السابقة، تثير دراستنا هذه عدة تساؤلات ، تحاول الإجابة عنها إبريقيا من واقع مجتمع الدارسة (الجزائري) ومنها:
– ماهي ميزات الممارسين للعلاج الشعبي في مجتمع الدراسة (الجزائري)؟ وماهي مصادر خبراتهم العلاجية؟
– أي الممارسات العلاجية الشعبية أكثر انتشارا وأكثر شهرة في مجتمع الدراسة (الجزائري)؟
– كيف يفسر الممارسون للعلاج الشعبي وقوع المرض والتخلص منه؟
– ماهي الوظائف العلاجية والوقائية التي يقدمها العلاج الشعبي في مجتمع الدراسة (الجزائري) ؟ ولماذا يلجؤون إليه الأفراد؟
– أي الميزات الاجتماعية والثقافية تغلب على مجتمع الدراسة المستفيد منه؟
– ما الملامح المستقبلية للعلاج الشعبي في مجتمع الدراسة (الجزائري)؟
4- دراسات الحالة لاشهر الممارسين للعلاج الشعبي:
أشرنا سابقا إلى أن التنوع الجغرافي والثقافي قد لعبا دورهما في مجتمع الدراسة (الجزائري) ، في تعدد وتنوع الممارسات العلاجية الشعبية، الأمر الذي ساعد على انتعاشه واتساع نطاق تخصصاته وازدياد مستفيديه. وقد شملت هذه التخصصات: العلاج بالأعشاب، والعلاج بالكي، والعلاج بالحجامة، والعلاج بالقرآن الكريم (الصرع والسحر والعين)، والعلاج بالتجبير والعلاج بالتدليك (المسد)، والعلاج بالقبض (الجياف)، والعلاج بالأولياء والعلاج بالرمل و العلاج بالماء المالح … الخ.
والدراسة الميدانية قد أثبتت أن العلاج بالأعشاب أكثر انتشارا في مجتمع الدراسة بصفة خاصة، والمجتمع الجزائري بصفة عامة. ثم يليه من حيث الأهمية الكي، فالتجبير، ثم التمسيد فالتوليد، ثم العلاج بالقرآن الكريم، فالقبض (اللمس)، ثم الحجامة. ثم هناك ممارسات ذاتية للحالات الطارئة مثل الوصفات العلاجية الشعبية المنزلية. وسوف نقتصر في دراستنا الميدانية هذه على بعض النماذج العلاجية الشعبية والتي نعتبرها أكثر انتشارا في مناطق مجتمع الدراسة (الجزائري).
أ- العلاج بالأعشاب والنباتات الطبية (ألعشاب أو العطار):
يمثل العلاج بالأعشاب والنباتات الطبية نمطا آخر، من أنماط الممارسة العلاجية الشعبية، يحترفه مجموعة كبيرة العدد من الممارسين قد تغطي مساحة مجتمع الدراسة (الجزائري) بشكل ملفت للانتباه. لكونهم يتوافرون على الخبرة والمعرفة والممارسة للأعشاب والنباتات الطبية وطريقة استخدامها وخصائصها العلاجية والوقائية ، وذلك عن طريق الوراثة أو عن طريق الاكتساب. ولعل ازدهار العلاج العشبي في مجتمع الدراسة (الجزائري) عامة يعود إلى توافر تغطية نباتية وبيئية مناسبة لنمو مختلف أنواع الأعشاب والنباتات العلاجية في مناطق الجزائر. ثم كثرة الأمراض وتزايدها موسميا ، وانعدام الخدمات الصحية الرسمية في الكثير من الحالات لاسيما في المناطق النائية. موازاة مع سهولة جلب الأعشاب والنباتات العلاجية المطلوبة. ولذلك نجد تمركزا لبيع الأعشاب سواء على مستوى محترفيها (العطارة) أو( العشاب)، أو على مستوى الأسواق الشعبية العمومية الأسبوعية نذكر أسواق (تلمسان) (الرمشي) (مغنية) (سبدو) (الغزوات) … الخ. ممارسات توحي بتعدد المعالجين الشعبيين بالأعشاب بحيث يغطون متطلبات المستفيدين منها.
وقد ورث هؤلاء الممارسين الحرفة عن الوسط العائلي (الأب أو الجد). أما البعض الآخر فقد اكتسب الحرفة عن طريق التجربة والمعرفة وإدراك أهمية الأعشاب والنباتات العلاجية بالقراءة والبحث العلمي المتواصل اعتمادا على علوم النباتات وكنوز التراث. وفي هذا المجال سوف نلقي بعض الضوء على (عطار) أو عشاب ورث الحرفة العلاجية الشعبية ، وآخر اكتسبها وسقلها بالمعرفة والاطلاع.
– العشاب الأول : وهو من مواليد بني وعزان ويبلغ من العمر 68 سنة ورث المهنة عن والده
واشتغل بالمستشفى الجامعي (تلمسان) لمدة طويلة الأمر الذي ساعده على سقل ممارسته العلاجية أكثر. وهو جد ملم وعلى اطلاع واسع بالمعرفة الصحية والوقائية ويقطن بحي (سيدي سعيد) (تلمسان) ، حي موقع الدراسة الميدانية يقدم هذا العشاب العلاج لمرضاه في عطارته وفي منزله حيث يقصدونه ، ويحاورونه في الأعراض المرضية فيقرر لهم العلاج العشبي المناسب ويحصل على الأجر مقابل هذه الممارسة . ويحصل المرضى على الدواء من محلات العطارة التي تملأ أحياء المدينة العتيقة (تلمسان). وقد حرص هذا العشاب على توريث هذه المهنة لأولاده لكنهم رفضوا واتجهوا نحو مواصلة تعليمهم واستكمال دراساتهم . ولهذا المعالج صلة وثيقة بالعلاج الرسمي وكثيرا ما يوجه مرضاه نحوه بفرض الاستفادة منه.
ومن أهم الوصفات التي يقدمها هذا المعالج لمرضاه، وصفات لعلاج أعراض الجهاز الهضمي ، والربو، والكلى ، والسكر ، والأمراض الجلدية. وقد حقق هذا العشاب شهرة على المستوى المحلي والوطني. ومريدوه متنوعون من الرجال والنساء كبار السن ومتوسطية.
– العشاب الثاني : هو شاب في الخمسين من العمر يعيش في حي من أحياء مدنية (الرمشي)
حصل على التعليم العالي ثم اتجه لقراءة الكتب لاسيما المتعلقة بالتراث الصحي والوقائي حول النباتات و الأعشاب العلاجية، والتعرف على فوائدها العلاجية المختلفة، وخصائصها، وقد أجرى التجارب عليها لدرجة أنه اكتسب دراية دقيقة بها حيث استطاع أن يحقق شهرة كبيرة
على المستوى المحلي والمناطق المجاورة لمجتمع الدراسة. وهو يقدم العلاج لمرضاه في بيته حيث يشخص لهم المرض ويقرر الدواء العشبي المناسب. ويتوافد عليه المرض من مختلف المناطق. ومن أهم وصفاته العلاجية التي يقدمها لمرضاه، الوصفات العلاجية الخاصة بعلة اليرقان (بوصفير) الواسع الانتشار بين الأفراد ، وهذا النوع من العلل لا ينجح فيه العلاج الرسمي بكفاءة ، ونجح المعالج الشعبي في علاجه.
وقد ساعد توافر الأعشاب والنباتات العلاجية هذا الممارس ليجري التجارب، ويضيف إليها الجديد، ويفهم خصائص جديدة لها. ومثل هذه النباتات إنما تنمو عشوائيا مثل (البنج الأسود) (بونجروف عندنا) على ضفاف الأودية والذي يستخدم كمخذر، كما تستخدم أوراقه الجافة كعلاج للربو، حيث تستخلص منه شركات الأدوية، مادة فعالة مهدئة للأعصاب والسعال العصبي وضيق التنفس. والاسم العلمي لهذا النبات هو (Hyoscymus muticus) ويستخلص منه الآن علاجيا مادة الاتروبين والهيوسيامين (5). ويتابع هذا العشاب مراحل نمو النبات ويجري عليه التجارب بنفسه وبطريقة شعبية.
أ-العلاج بالتجبير (الجبار) (الكسور والفلتات المفصلية):
ممارسة علاجية شعبية هي الأخرى واسعة الانتشار في مجتمع الدراسة (الجزائري) ، فلا تخلو منطقة من مناطق مجتمع الدراسة من (جبار) يتولى مهمة علاج الكسور العظامية، والفلتات المفصلية وهي ما يصيب عضلات الجسم من إلتواءات أو إرتخاءات أو غير ذلك. زيادة على معالجة ما يصيب العظام من تشققات. ويحظى الجبار بثقة مطلقة من مستفيديه، أكثر مما يحظى به أطباء العظام. ويوجد في منطقة (القبار) بولهاصة ” السيد لحول الميلود” شيخ يتجاوز (70) سنة متزوج لا زال يمارس بعض الأنشطة المتمثلة في الصناعة التقليدية. وقد ورث خبرته عن الأب والجد، ذلك أن جده هو أول من مارس هذه الحرفة، وهو يؤكد لنا على أن خبرته تعتبر (وهبة) من الله تعالى، وبالتالي فهو لا يطالب بدفع الأجر، وإنما يتقبل ما يمنح له ولو كان رمزيا. والواقع أن هذا التصرف قد لامسناه في دراستنا رغم شحاحة مستواه المعيشي وظروفة الصحية ولعل هذه صورة أخرى من صور الاعتقاد بإضفاء صفة القداسة على الممارس والممارسة ذاتها (6).
ويمارس السيد (لحول الميلود) العلاج في منزله ، حيث يخصص مكانا مستقلا يقابل فيه مرضاه ويقوم بعلاجهم ، وقد ينتقل إلى المريض أينما وجد وفي أي وقت ودون تردد ، وهو لا يتقيد بمكان ولا بموعد. ولعل هذه التسهيلات العلاجية التي يتمتع بها النسق العلاجي الشعبي هي جعلت المستفيدين منه لا يرغبون في الإقبال على العلاج الرسمي ولا يثقون فيه. والسيد (لحول الميلود) متخصص في هذا النوع من العلاج الشعبي دون غيره على عكس بعض المعالجين الآخرين.
وقد أدلى السيد (لحول الميلود) عن قصور العلاج الرسمي في علاج الكسور بحادثتين أولاهما لأمة التي انزلقت على قشرة برتقال فسببت لها فصلا في رجلها. وكان ذلك في غيابه فذهبوا بها إلى المستشفى فوضع الأطباء رجلها في كومة من الجبس فقط. وعندما عاد مزق الجبس بالمنجل والسكين وعالجها العلاج الشعبي اليدوي فشفيت. وثانيهما لطفلة وقعت على رجلها فانفصلت فذهبت بها أمها إلى طبيب العظام ليعالجها فلم تتحسن. وبعد فترة رأتها امرأة وهي تحمل ابنتها على كتفيها إلى نفس الطبيب فنصحتها باللجوء إلى السيد (لحول الميلود) فجاءته فارجع العظم إلى مكانه ، فصرخت الطفلة فانطلقت تهرول حتى وصلت إلى بيتها بعد أن كانت محمولة على كتف أمها.
وتنحصر الممارسة العلاجية للسيد (لحول الميلود) في تحسس المواضع المحيطة بالكسر أو الانفلات عن طريق التلمس بالأصابع حتى يستطيع تحديد الموضع بدقة، ثم يدلكه بالزيت حتى يستخزح العضلة السلبية للألم، ثم يشده بقطع من القماش في انتظار الشفاء. والملاحظ أن الشق عند الأطفال يبرأ دون علاج. بينما يعالج الفصل أو (الفلتات) بتحريك المفصل في الاتجاه الصحيح حتى يقع في (الخن) ملتقى المفصلين.
ويتردد على السيد (لحول الميلود) مستفيدون من علاجه كثيرون ومن مختلف الفئات الاجتماعية محليا، ومن المناطق المجاورة لاسيما الرجال والنساء متعلمون وغير متعلمين خاصة وأن علاجه لا يستغرق دقائق معدودة، كما أنه لا يستخدم الجبس، زيادة على عمق الثقة في قدراته وخبرته العلاجية، ناهيك عن زهده للأجر أو انعدامه.